|
|
عضو برونزي
|
|
رقم العضوية : 54354
|
|
الإنتساب : Aug 2010
|
|
المشاركات : 254
|
|
بمعدل : 0.04 يوميا
|
|
|
|
|
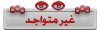

|
كاتب الموضوع :
فارس اللواء
المنتدى :
المنتدى العام
 بتاريخ : 04-03-2012 الساعة : 01:50 AM
بتاريخ : 04-03-2012 الساعة : 01:50 AM
ثانياً: عولمة الحداثة ودرء آفاتها
وفي الباب الأول (التطبيق الإسلامي لمبدأ النقد الحداثي) تناول طه عبد الرحمن نظام العولمة والتعقيل الموسع، فبين الآفات الخُلُقية للعولمة؛ بوصفها (العولمة) فعلاً حضارياً متواصلاً يتجه إلى إقامة رابطة واحدة بين سكان المعمورة عبر تعقيل مخصوص، يخُضع التنمية لسلطان الاقتصاد، ويخُضع العلم لسلطان التقنية، ويخضع الاتصال لسلطان الشبكة، وقعت في آفات خلقية ثلاث تختلف باختلاف هذه الوجوه من الإخضاع التي مارسها التعقيل العولمي، وتتلخص هذه الآفات في الإخلال بمبادئ التزكية والعمل والتواصل.
فآفة الإخلال بمبدأ التزكية تقوم على تقديم المنفعة المادية على المصلحة المعنوية؛ ذلك أنَّ الاقتصاد في الغرب غدا مقياس كل تنمية، وحصل اقتناع بإمكان أن يحل النمو الاقتصادي كل المشكلات، ويجلب كل تقدُّم، ويقرب الفقراء من الأغنياء. وأنتج هذا التوجه شركات وهيئات مالية لا تعترف إلا بقانون المصلحة المادية والربح، بلا حدّ ولا قيد غير مادي (معنوي)، وبهذا يتأكد تعارض هذا التوجه مع مبدأ "التزكية"، التي تقوم على الصلاح والأخلاق، لا على المنفعة المادية فحسب، ولا تطلب عموم المنافع بل تطلب الصالح منها.
وآفة الإخلال بمبدأ العمل تستند إلى تقديم الإجراء الآلي على العمل المقصدي؛ وذلك حين انعكست العلاقة بين العلم والتقنية، فأصبح العلم النظري تابعاً لها بعد أن كانت تابعة له، وصار وسيلة في يدها، توجهه بحسب الحاجيات الاستهلاكية المتزايدة. وهنا حدث طغيان التجريب والإجراء على المقاصد والأعمال التي تقوم على الجمع بين مقتضى التحكّم ومقتضى الحكمة.
أما آفة الإخلال بمبدأ التواصل فتستند إلى تقديم المعلومة البعيدة على المعرفة القريبة، فالشبكة الدولية "الإنترنت" التي سهّلت عمليات الاتصال بين البشر، ووفّرت كمّاً هائلاً من المعلومات جعلت فعل الاتصال يتم بين آلتين أكثر مما يتم بين آدميِّين، كما أن هذا الاتصال طغى فيه الطابع "الإعلاني" على الطابع "الإعلامي"، والنتيجة أن هذا النمط من تناقل المعلومات فشل في تحقيق تجاوب البشر من حيث هم ذوات.
ولا قدرة لنظام العولمة على دفع هذه الآفات بنفسه ومن داخله؛ لأنه لا يفرز إلا قيماً أخلاقية من جنسه، في حين يحتاج هذا الدفع إلى قيم أخلاقية من غير جنسه؛ ولا وجود لها إلا في الدين الإلهي. وأحق الأديان بهذه المهمة التقويمية وأقدرها عليها هو الدين الإسلامي، نظراً لثبوت توسُّع تعقيله ودخول العولمة في زمنه الأخلاقي. فكل مسلم معاصر مسؤول (مسؤولية غير مباشرة) عن العولمة ولو لم يكن صانعها التاريخي؛ إذ الزمن الأخلاقي زمنه هو دون سواه؛ لأنه زمن القيم التي تجددت تجددها الآخر مع دينه. وإبراء ذمته من هذه المسؤولية يحتم عليه تعقب مظاهر العولمة، وتفحص مواضع القصور الخلقي فيها، ليدفعها ويحذر منها ويغيَّرها ما استطاع.
ثم فصَّل طه عبد الرحمن المبادئ الإسلامية لدرء الآفات الخلقية للعولمة، فأكّد أن واجب الدين الخاتم -كما قال- هو أن يرتقي بالاتجاه المادي المضيّق الذي أخذ به أرباب العولمة إلى مجال موسَّع يعيد الاعتبار للأخلاق في العلاقات التي تقيمها العولمة بين أفراد البشرية، عاملة على توحيد نمطهم في الحياة. وأهم المبادئ التي تسعف في هذا المجال ثلاثة: ابتغاء الفضل، والاعتبار، والتعارف.
فمبدأ ابتغاء الفضل يقضي بإعادة النظر في المفهومين الاقتصاديين؛ مفهوم "التنمية الاقتصادية" ومفهوم "المنفعة"، فليست كل تنمية اقتصادية ضرورية، ولا كل منفعة مادية صالحة؛ إذ إنّ التنمية الصالحة لا تكون إلا بتكامل المقوم الاقتصادي مع المقومات الأخرى للتنمية، مع دوام اتصاله بالأفق الروحي. وإذا كان اقتصاد السوق يقوم على مطلق "التجارة" التي تتلخص في أفعال البيع والشراء مجردة من الاعتبار الخلقي، فإن "ابتغاء الفضل" كائن تحت مظلة الأخلاق. والفضل لا يعني الخير المادي الصرف، وإنما هو الخير الذي تتحقق به الفضيلة، مادياً كان أو معنوياً، وينتج عن هذا أن التنمية وفق المنظور الإسلامي تنمية مزدوجة، "تزكية للمال" و"تزكية للحال"، تتكامل مع ضروب التنمية الأخرى التي ترتقي بالإنسان وتخلق بيئة عالمية سليمة.
ومبدأ ابتغاء الفضل -وفق هذا المفهوم- يقتضي تبعية الاقتصاد لمقومات التنمية الأخرى، وتبعية المنفعة للأفق الروحي للإنسان. ومتى تقررت هذه التبعية للمقومات الأخرى وللأفق الروحي، صار بالإمكان الارتقاء من نطاق التنمية الضيق إلى رحاب التزكية الواسعة، التي تردّ كل فضل إلى المتفضل الأسمى سبحانه، وتذكّر الإنسان بأن الله هو المالك الحقيقي الذي يتكرم على الإنسان بما شاء من فضله حتى يتقرب به إليه، كما أن هذا الإحساس هو الذي يخفف من غلواء المادية الكامنة في السلع، ويبرز معناها الروحي. وهكذا يجعل طه عبد الرحمن مبدأ ابتغاء الفضل القيم الأخلاقية والروحية في صلب عملية التنمية الاقتصادية، وهو ما افتقده واقع الحداثة الغربية.
أما مبدأ الاعتبار فيوجب إعادة النظر في المفهومين العلميين: مفهوم "التطبيق التقني للعلم" ومفهوم "البحث العلمي"؛ فليس كل تطبيق نافعاً ولا كل بحث مشروعاً، فالمعرفة وفي سياق "النظر الاعتباري" -وفق الرؤية الإسلامية- تربط أسباب الأشياء بالقيم الخلقية التي تنطوي عليها، وترفع المعرفة عن أن تكون جملة من الإمكانات التقنية قد تنفع أو تضر لكي تصبح إمكانات عملية تنفع ولا تضر.
ومن مقتضيات الاعتبار تقرير تبعية الأسباب في الأشياء للحكم التي من ورائها، وتبعية أحوالها للمآلات التي تنتهي إليها؛ ومتى تقررت هذه التبعية للحكم والمآلات، صار بالإمكان الارتقاء من نطاق الإجراء الآلي إلى رحاب العمل المقصدي؛ فالمعيار الذي تأخذ به المعرفة في سياق النظر الاعتباري هو المآل لا مجرد الحال. وتكون هذه المعرفة مقبولة إذا ظهر أن مآلها يعود بمزيد من التخلق، ومردودة إذا ظهر أنها تعود بنقصانه، بينما يصر التطبيق الإجرائي على تطبيق المعارف والتقنيات مهما كانت مآلاتها. وبهذا يتبين أن مبدأ "الاعتبار" الإسلامي من شأنه أن يحد من التطبيقات غير المنضبطة للتقنية، ويعدل مفهوم البحث العلمي حتى يبقيه خادماً للحاجات لا خالقاً لها، وخاضعاً للمقاصد والمآلات لا للأسباب والأحوال.
وأما مبدأ التعارف فيقضي بإعادة النظر في المفهومين الاتصاليين: مفهوم "الاستزادة غير المحدودة من المعلومات" ومفهوم "المعلومة المجردة"؛ فليست كل زيادة في المعلومات مطلوبة، ولا كل معلومة محايدة. فإذا كان التواصل المعلوماتي تواصلاً خبرياً –فقط- لا اعتبار فيه للقيمة الخلقية، فإن التعارف (الإسلامي) تواصل خبري لا ينفك عن القيمة الخلقية المحمودة. ففي سياق التعارف لا ينفك الخبر عن الخير والنفع، وهذا يتطلب قيوداً وآداباً لا تتوفر في المعلومات المجردة، وهذا المبدأ يهوّن من شأن التجميع المتسارع للمعلومات دون إعمال النظر في جدواها ونفعها.
كما أن عملية التواصل -وفق منظور التعارف- يقضي بتبعية نقل الخبر لفعل المعروف، وتقرير تبعية العلاقة بين المخبر والمتلقي لاعتراف أحدهما بالآخر؛ ومتى تقررت هذه التبعية للمعروف والاعتراف، صار بالإمكان الارتقاء من نطاق الاتصال المعلوماتي إلى رحاب التواصل الحقيقي. ذلك أن العلاقة بين الملقي والمتلقي يفترض أن تكون علاقة أخلاقية تقوم على المعاملة بالحسنى والاحترام، والانفتاح والتسامح، والتعاون والتقارب والتوادد، مع اعتراف المتلقي بفضل الملقي واختلافه عنه. وفي هذا إقرار بالتميز الثقافي والخصوصية الحضارية للملقي، وهذا ما يحقق مشروعية عملية التواصل والتعاون.
| |
|
|
|
|
|