|
|
عضو برونزي
|
|
رقم العضوية : 73847
|
|
الإنتساب : Aug 2012
|
|
المشاركات : 308
|
|
بمعدل : 0.06 يوميا
|
|
|
|
|
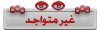

|
كاتب الموضوع :
حسين الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الثقافي
 بتاريخ : 15-11-2012 الساعة : 12:14 AM
بتاريخ : 15-11-2012 الساعة : 12:14 AM
علي الوردي .. بين ازدواج الشخصية العراقية وصراع البداوة والحضارة / وجود لطفي
 علي الوردي علي الوردي
قدم الناشط السياسي عبد الرزاق الحلفي جلسة في التجمع الثقافي في البصرة عنوانها (علي الوردي.. حياته وأفكاره) قدمه الناشط السياسي ناصرالكناني تحدث فيها عن حياة علي الوردي متتبعا إياها منذ ولادته وابرز المواقف التي اتخذها الوردي وخاصة أيام النظام السابق وابرز كتبه وبعض آرائه في المجتمع العراقي وتسجيله لتاريخ العراق الحديث في كتبه المختلفة وبعض المفاهيم التي ارتكز عليها في تأسيسه لمنهجه في علم الاجتماع
ثم فتح باب المناقشات التي ابتدأها الكاتب خالد خضير الصالحي الذي قال إن المحاضرة كان يعوزها الكثير لتبدو مكتملة، فقد كان العنوان (علي الوردي.. حياته وأفكاره) فضفاضا ويعاني تناقضا داخليا حيث لا علاقة بين حياة علي الوردي وشكل أفكاره بالضرورة وكان الواجب التركيز على المرتكزات الفكرية لعلي الوردي وهي عديدة يمكن إيراد بعضها بعجالة منها:
التناقض في الشخصية العراقية باعتباره المفهوم المركزي عند الدكتور الوردي، وفهم الوردي للعوامل الفاعلة في التحولات الاجتماعية والتاريخ، وهجومه على الإيديولوجيين من مختلف الاتجاهات والذين يسميهم وعاظ السلاطين، والهجوم المزدوج الذي تعرض له الوردي من اليساريين ومن رجال الدين معا لأنه كان مع مجموعة من المثقفين المستقلين يمثلون التيار المستقل في الثقافة العراقية من الذين كانوا يتعرضون الى مختلف الضغوط جراء استقلاليتهم، ولم يتحدث المحاضر عن آراء علي الوردي حول الأدب والثقافة، وغيرها من الموضوعات التي كان يمكن ان تشكل موضوعا للحديث عن الوردي..
وأضاف الصالحي أن مصطلح (ازدواج الشخصية العراقية) استخدمه الوردي في محاضرة له في بغداد 1951، وكان يستند حسب قول الوردي إلى جملة من القرائن "فالعراقي اقل الناس تمسكا بالدين، وأكثرهم انغماسا في النزاع بين المذاهب الدينية، فتراه ملحدا من ناحية وطائفيا من ناحية أخرى"، وكان هذا المصطلح عند الوردي يقترب كثيراً من أعراض مرض انفصام الشخصية، فالوردي يصف (أعراضه) بقوله "الفرد العراقي، في الواقع ذو شخصيتين، وهو إذ يعمل بإحدى الشخصيتين ينسى ما فعل آنفا بالشخصية الأخرى... (وذلك) مرده إلى ظهور نفس أخرى فيه لا تدري ماذا قالت النفس الأولى وماذا فعلت"؛ وبذلك يكون قد عمم حالة مرضية إكلينيكية على شعب بأكمله، والصحيح كما يؤكد الدكتور قاسم حسين صالح ان هنالك فرقا بين حالة التناشز او التنافر او عدم التطابق بين الفكرة والمعتقد الذي يحمله الفرد كعضو في مجتمع، وبين التصرف الذي يقوم به، وهي حالة شائعة بين البشر، ولا ينفرد العراقيون ولا يمتازون بها على غيرهم، وان الفكرة ترجع الى ابن خلدون وقد استعارها الوردي ولكنه ادخلها ضمن نسيج الشخصية الفردية بينما ابن خلدون ادخلها ضمن نسيج المجتمع كصراع بين نسقين حضاريين متعارضين وضاغطين على المجتمع والشخصية العراقية هما: البداوة والحضارة ؛ بينما قال علي الوردي بأنها تنبع داخل الشخصية العراقية وتصبغ المجتمع بصبغتها .. وانتهى المتحدث إلى أن أسبابها اجتماعية وواقع العراق السياسي، وهو الأمر الذي أكده متحدثون آخرون كالكاتب رشيد هاشم فهد الذي أضاف أن الشخصية العراقية كأي شخصية وفي أي مجتمع وان القوى السياسية والقوى المهيمنة على المجتمع العراقي هي التي تهيئ الأرضية القابلة لنمو النفاق الاجتماعي، وهي السياسة التي تبنتها كل الانظمة السياسية التي حكمت العراق، وهو ما اكده بعدهما الناشط السياسي سعيد المظفر الذي اكد طروحات المتحدثين السابقين، واضاف الكاتب رشيد هاشم فهد: " بالنسبة الى تبويب المجتمع الى بداوة وحضارة وهو التبويب الذي امن به علي الوردي يفتقر الى الدقة، وقياسا الى التبويبات التي اعتقدها بعض الفلاسفة كان تقسيم الوردي بالنسبة اليها متخلفا وغير دقيق. ماركس كان افضل منه حين قسم المجتمع الى طبقات اي الى ما يتعلق بعلاقة هذه الطبقة ام تلك بوسائل الانتاج وهو التقسيم الذي اشتهر به ماركس، وغيره من الفلاسفة والمفكرين الذين راحوا يقسمون المجتمعات على اساس اعراقها او دياناتها هم ايضا افضل من الوردي لان تقسيمهم هذا كان يعتمد على معطيات تجعلهم يدافعون عن آرائهم على نحو قوي، اما الوردي فلم يكن كذلك لانه اهمل مكونا مهما وهو الريف، والبداوة بالنسبة للريف من حيث الحجم لا تساوي شيئا، واعتقد انه تعمد اهمال الريف تناغما مع انطباع الامريكيين عن العرب، وهو الدارس في الولايات المتحدة، حيث الانطباع السائد وقتذاك وربما الى يومنا هذا كان بداوة وحضارة، في حين ان المكون الاساس بالنسبة للمجتمع العراقي كان الريف، وكان الصراع بينه وبين المدينة قائما الى يومنا هذا ولكل من الريف والمدينة سلوك وثقافة تميزه؛ فقد شاهدت افلاما وثائقية امريكية واوربية عديدة تعكس انطباعهم عن العرب عموما والعراقيين خصوصا يتحدثون بها عن صحراء ومدينة. واعتقد ان الوردي في تبويبه للمجتمع العراقي جاء منسجما مع هذا الانطباع حتى قبل الديانة الاسلامية كانت هناك مدن وارياف وبادية، بينما الجانب السياسي هو الحاسم في رسم سلوك الناس وثقافتهم، المثل يقول الناس على دين ملوكهم مع ان طبيعة النظام السياسي كانت في اي مجتمع ذات دور مهم في ازالة ثقافات وترسيخ ثقافات وسلوكيات اخرى. واعتقد ان اهمال الوردي لهذا الجانب واحد من اثنين: إما انه كان يهادن الانظمة السياسية المتعاقبة على حكم العراق والتي عاصرها، او اراد ان يلقي بالكرة في ساحة المجتمع العراقي ويحمله كامل المسؤولية متاثرا برأي الاجداد، او انه اراد ان يكون لعلم الاجتماع ما يميزه ؛ ان الازدواجية والنفاق تحدث عنهما وكانهما مزروعتان او نابتتان في خلايا جسم العراقي بينما هما تحصيل حاصل لعوامل عدة من اهمها طبيعة الانظمة الحاكمة للعراق وهي جميعا انظمة قمعية تتحلى بالقسوة المعروفة فقد كانت متشابهة من حيث القسوة.
ان طبائع العراقي التي تحدث عنها الوردي كانت موجودة الى وقت قريب في اوربا، فالمجتمعات الاوربية كانت تتقاتل في ما بينها لاسباب دينية او عرقية نعم ان البلدان الاوربية كانت تتقاتل من اجل النفوذ والهيمنة هذا صحيح ولكن حصانة شعوب اوربا وقتذاك نابعة من عقائد دينية او عرقية، ولكن الكثير من هذه الطبائع تغيرت عندما اتجهت بلدان اوربا نحو اقامة انظمة مدنية وقيام دول ذات مؤسسات اي قيام انظمة العدل والمساواة وابعاد كل الاثنيات من الجانب السياسي"، وواصل خالد خضير الصالحي القول بأن الوردي قد تعرض الى هجوم مزدوج من السلطات، ومن رجال الدين، ومن اليسار على حد سواء؛ فيذكر الدكتور عبد الحسين شعبان ان الوردي "كذلك تعرض الى هجوم من اليسار الماركسي، فقد كانت الحركة الشيوعية تعتبر افكار علي الوردي افكارا مثالية لانها لا تستند الى مبدأ الصراع الطبقي"، وقد رد المحاضر عبد الرزاق الحلفي بان المعقب الصالحي استغل الجلسة من اجل استعراض عضلاته الثقافية، فرد عليه الاخير انه لا يختلف عن أي حزبي يستخدم آليات (القتل الرمزي) التي بسط القول فيها محمد غازي الاخرس في كتابه (خريف المثقف في العراق) وهو ذات التسقيط الذي برعت به الاحزاب السياسية العراقية على اختلاف ايديولوجياتها، وهي اساليب رخيصة لا تستحق الاحترام؛ وان اولى مهمات بناء الدولة المدنية هو تحرير الثقافة من هيمنة الايديولوجيا الحزبية وبناء ثقافة مدنية مستقلة متعافية من النفعيات..
| |
|
|
|
|
|