|
|
عضو برونزي
|
|
رقم العضوية : 4273
|
|
الإنتساب : Apr 2007
|
|
المشاركات : 314
|
|
بمعدل : 0.05 يوميا
|
|
|
|
|
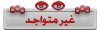

|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
 الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين
الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين
 بتاريخ : 26-04-2007 الساعة : 08:04 AM
بتاريخ : 26-04-2007 الساعة : 08:04 AM
الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين smilies/015.gif
الجبر: هو الاعتقاد بأن الله تعالى يجبر عباده علي الفعل خيراً كان الفعل أو شراً، حسناً كان أو قبيحاً، دون أن يكون للعبد إرادة واختيار في الامتناع.
التفويض: هو الاعتقاد بأن الله تعالى فوض أفعال العبـاد إليهم يفعلون ما يشاءون علي وجه الاستقلال، دون أن يكون لله سلطان على أفعالهم.
الأمر بين الأمرين: هو الاعتقاد بأن الله تعالى كلف عباده ببعض الأفعال ونهاهم عن أخري وأمرهم بالطاعة، بعد أن هداهم إلى ما يريد فعله وما يريد تركه، وبعد أن منحهم القوة في الفعل والترك دون أن يجبر أحداً على الفعل أو الترك. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها.
القائلون بالجبر
استدلوا علي مذهبهم بأدلة عقلية، وأخري نقلية. فمن أدلتهم العقلية:
1ـ إن فعل العبد مقدور لله تعالى لان فعله من جملة الممكنات التي هي منه تعالى، فلو قلنا بأنه يقع بقدرة العبد وحده لزم تعطيل قدرة الله، وان قلنا بأنه يقع بقدرتهما معاً لزم اجتماع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد. فيتعين أن يكون الفعل من الله.
والجواب علي دليلهم هذا هو انه ليس كل مقدور له تعالى هو من فعله المباشري فمجرد كون فعل العبد مقدوراً له تعالى لا يستلزم أن يكون من فعله أيضاً.
2ـ إن جميع ما سواه مورد إرادته الأزلية الأبدية وان إرادته عين ذاته وهي العلة التامة لتحقق المعلول، فلا اثر لإرادة العبد في فعله.
ويجاب بأن ذلك مبنى على جعل الإرادة من صفات الذات. لكن الحق أنها من صفات الفعل، فتكون حادثة بحدوثه. بل إرادته عين فعله كما في الروايات.
3ـ إن كل ما علم الله وقوعه فهو واقع لا محالة وما علم امتناع وقوعه فهو ممتنع حتماً، فإذا علم الله وقوع الكفر استحال على الكافر إرادة الإيمان.
ويجاب: إن العلم من مقدمات الإرادة المتقدمة علي الفعل وليس سبباً تاماً لحصول المعلوم بوجه من الوجوه، بل علمه تعالى تعلق بأفعال العباد من حيث إنها مختار العبد، لا أن يتعلق العلم بأحد طرفي الاختيار فقط.
وأما أدلتهم النقلية فهي آيات في القرآن ظاهرها إن الله تعالى خالق الأفعال منها قوله (والله خلقكم وما تعملون)[الصافات/96]، وقوله (يضل من يشاء ويهدي من يشاء)[إبراهيم/4]، وقوله (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي)[الأنفال/17].
ويجاب عنها أولاً بأنها معارضة بآيات أخرى أكثر عدداً وأصرح دلالةً على الاختيار كقوله تعالى (كل امرئ بما كسب رهين)[الطور/21]، وقوله [اليوم تجزي كل نفس بما كسبت)[غافر/17]، وقوله (اليوم تجزون ما كنتم تعملون)[الجاثية/28]، وقوله (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)[الكهف/29].
وثانياً بأن سياق تلك الآيات والقرائن المحيطة بها تدل على أن المراد منها غير ما ذهبوا إليه فمثلاً، كان الناس يصنعون تمثالاً من الخشب فيعبدوه، فيقول تعالى إن ما عملتموه من الخشب أو شيء آخر هو مخلوق مثلكم والمخلوق لا يكون رباً، والله هو الذي خلقكم وخلق هذه الأشياء التي تعبدونها. وكذلك نفى الرمي عن النبي ـ (صلي الله عليه وآله) ـ إنما هو بالنسبة إلى الأثر الخارق للعادة لا فعل الرمي الصادر منه (صلي الله عليه وآله).
ومجمل القول في الجبر انه لم يصادم العقل والنقل فحسب بل هو مستلزم لنفي الحسن والقبح العقليين المتفق عليه بين العقلاء، كما يستلزم منه نفي الثواب والعقاب الثابتين في جميع الشرائع كما يلزم منه تجويز الظلم على الله تعالى. وللسائل أن يسأل المجبرة انه إذا كان الله اجبر العباد على أفعالهم فما وجه السؤال في قوله تعالى: (ولتسألن عما كنتم تعملون)[النحل/93]. فان قالوا عن الأفعال التي تصدر منهم باختيارهم فقد أبطلوا الجبر. وان قالوا إن السؤال عن أفعال أجبرهم الله عليها قيل لهم فما هو الوجه في سؤال العبد ما دام الله هو الفاعل؟ وماذا يترتب على سؤال العباد عن المسؤولية التي نفاها الله تعالى عن المكره والمرغم على فعل الشيء بقوله تعالى: (.. إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان)[النحل/106].
القائلون بالتفويض
يذهبون إلى كون الأفعال مختارة باختيار العبد، ولا دخل لاختيار الله تعالى فيها فلا لبواعثه وزواجره ولا لتوفيقه وخذلانه دور في فعل العبد، بل أباح له ما شاء وفوض إليه أمر الخلق والرزق. واستدلوا على مذهبهم بأدلة عقلية ونقلية أيضاً منها:
1ـ لو لم يكن الإنسان موجداً لأفعاله لما صح تكليف العباد ولا المدح والذم ولبطل الثواب والعقاب، وللزم القول بالجبر الباطل. مع انه لا يصح أن تكون السيئات والأفعال القبيحة مورداً لإرادة الله تعالى.
2ـ استدلوا بآيات تدل على التفويض كقوله تعالى: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)[الكهف/29]، وغيرها من الآيات.
وهذا أيضاً مذهب باطل فهو لو صح لكان الله تعالى بعد أن خلق الخلق ومكّنهم من أفعالهم عجز عن تدبير أمرهم وإدارة شؤونهم وهذا يثبت عجزه تعالى عن ذلك علواً كبيراً.
وبطلانه بالكتاب والسنة واضح لاشتمالها على أوامر الله ونواهيه التي حددت للعباد أعمالهم وإلزامهم بفعل ما هو حسن ومنعهم عن القبائح. ولم يكن الله تعالى في تمكين عباده مجبراً لهم عليها ولا مفوضاً إليهم أعمالهم بل العكس فقد جعل كمال العبادة والطاعة تفويض العباد أمرهم إليه كقوله تعالى: (وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد)[المؤمن/44]، ولو كان الأمر كما زعموا لما كان لطلب الاستعانة منه تعالى وجه.
أما الآيات فغاية ما يستفاد منها أن الإنسان هو الفاعل وعنه يصدر جميع أعماله، أمّا انه ليس لإرادة الله تعالى وقدره وقضائه دخل فيها فلا يستفاد منها. وهي من هذه الجهة معارضة بالآيات الدالة على أن أفعال العباد من الله: (قل كلّ من عند الله)، وأيضاً معارضة بالآيات الدالة على طلب الاستعانة منه تعالى كقوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) وقوله (وأفوض أمري إلى الله)[المؤمن/44]. وكذا مخالفة لما ورد عن المعصومين (لا حول ولا قوة إلا بالله).
وبالجملة فان الآيات والروايات لا يمكن أن يستفاد منها التفويض الكلي للعباد المقابل للجبر، ويمكن حمل الكلمات على التفويض ألاقتضائي بأن يقال إن نهاية استغنائه تعالى عن خلقه يقتضي إيكال الإرادة إلى العباد بعد بيان طريق الحق والباطل وإتمام الحجة عليهم، لكنه لم يفعل لمصالح كثيرة، بل جعل إرادته مسيطرة على إرادة العباد لا على نحو يلزم منه الجبر.
القائلون بالأمر بين الأمرين
تفردت به الإمامية لما ورد عن الأئمة الهداة سلام الله عليهم انه: (لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين)، المراد به أن الله تعالى أودع القدرة في عباده وبها بعد وجود الدواعي يصدر الفعل من الفاعل وينسب إليه مباشرة، فهو غير مجبور لتعلق قدرته بطرفي الفعل معاً.
وتوضيحه: إن أفعال العباد منحصرة في ثلاثة أقسام فهي إما من الحسنات، أو من السيئات، أو من المباحات. ولا ريب في أن الأمر بين الأمرين متقوم بالانتساب إليه تعالى وإلى العباد انتساباً يحكم بصحته العقلاء، ومن رضائه تعالى بالحسنات وترغيبه إليها والتأكيد في إتيانها والثواب عليها أو العقاب على الترك في بعضها يصح الانتساب إليه تعالى ويسمي ذلك بالانتساب ألاقتضائي لا يبلغ حد الإلجاء والاضطرار. ومن إذنه في المباحات وترخيصه لها صح انتسابه إليه تعالى اقتضاءً كما هو الحال في الحسنات، فتحقق بالنسبة إلى الحسنات والمباحات رضاؤه وقضاؤه تعالى.
ومن خلقه للنفس الإمارة والشيطان صح نسبة السيئات إليه تعالى لكن لابمعنى رضائه بها ورغبته فيها أو ترغيبه، فيصح نسبة الخلق التسبيبي إليه تعالى في السيئات ويجري هذا الوجه في الحسنات والمباحات فان هذه النسبة الإقتضائية توجد في الجميع.
وأما نسبة الفعل الى الفاعل فان الله تعالى خلق الذات المختارة القادرة علي السيئات فاذا فعل العبد السيئة بسوء اختياره مع نهيه تعالى واظهار سخطه فإن الفعل ينسب الى العبد مباشرة، واما منشأ النسبة الى الله تعالى فلأنه خلق الذات القادرة المختارة مع إبلاغ النهي والتوعيد، وقد علم بها وقضاها علي نحو الاقتضاء لإقضاء الحتم ولامنقصة في هذا القسم من النسبة ابداً، ولعل هذا أحد معاني قوله تعالى » قل كل من عند الله « النساء 78.
وبعبارة أخري ان في الحسنات والمباحات تتعدد جهة الانتساب إليه تعالى من الرضا والقضاء والإذن والترغيب وخلق الذات القادرة المختارة، وفي السيئات منحصرة بخصوص الأخيرة والقضاء ألاقتضائي مع النهي والتوعيد.
ومن ذلك يعلم أن الهداية والضلالة ليست من ذاتيات العبد بحيث لا اختيار له فيها ولا من لوازم الذات كلزوم الزوجية للأربعة وإلا لما كانت قابلة للتغيير والتبديل ولبطل التكليف والثواب والعقاب، بل هي من قبيل الإعراض الخارجية القابلة للزوال والتغيير والتي للاختيار فيها دخل مع التوفيق والهداية منه تعالى.
في الاحتجاج ج2 ص198 وكشف الغمةج3 ص82 عن الإمام الرضا: (ألا أعطيكم في ذلك أصلاً لا تختلفون فيه ولا تخاصمون عليه أحداً إلا كسرتموه؟ إن الله عز وجل لم يطع بإكراه ولم يعص بغلبة. ولم يهمل العباد في ملكه فهو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه، فان ائتمر العباد بطاعة لم يكن الله عنها صاداً ولا منها مانعاً، وان ائتمروا بمعصية فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل وان لم يحل وفعلوا فليس هو الذي أدخلهم فيه).
والمراد إن إرادة الصرف عن مراد العبد من الله، وهو محسوس لكل أحد، فكم من مريد لشيء يصرف عن إرادته وكم غير مريد يصادفه ما يشتهيه
السيد حسين الحسيني الزرباطي
| |
|
|
|
|
|





