|
|
شيعي فاطمي
|
|
رقم العضوية : 23528
|
|
الإنتساب : Oct 2008
|
|
المشاركات : 4,921
|
|
بمعدل : 0.77 يوميا
|
|
|
|
|
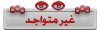

|
المنتدى :
منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام
 الحنان العميق
الحنان العميق
 بتاريخ : 18-08-2009 الساعة : 02:31 AM
بتاريخ : 18-08-2009 الساعة : 02:31 AM
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
الحنان العميق
أدرك علي أن منطق الحنان أرفع من منطق القانون، وأن عطف الإنسان على الإنسان وسائر الكائنات، إنما هو حجة الحياة على الموت، والوجود على العدم!
ولم يكن موقف عليّ من المرأة لك الموقف الذي صَوَّروه!
إذا كان من عدالة الكون وتكافؤ الوجود أن تلتقي على صعيد واحد بَوارحُ الصيف ومُعْصِرات الشتاء، وأن تَفْنى في حقيقةٍ واحدةٍ السوافي والأعاصير والنُّسَيمات اللّينات، وأن تحملَ الطبيعةُ بذاتها، بكلّ مظهر من مظاهرها، قانونَ الثواب والعقاب، فمن هذه العدالة أيضاً ومِن هذا التكافؤ أنْ تتعاطى قوى الطبيعة وتتداخل سواءٌ في ذلك عناصرُ الجماد وعناصر الحياة. وسواءٌ في ذلك ما انبثق عن هذه أو انسلخ عن تلك.
ولما كانت صفات الإنسان وأخلاقه وميوله وأحاسيسه منبثقة عن عناصر الحياة التي تتّحد فتؤلّف ما نسميه شخصية الإنسان، فهي متعاطية متداخلة، تُثبتُ ذلك الملاحظةُ الطويلة والموازنةُ الدقيقةُ ثمّ قواعدُ العلم الحديث الذي لاحَظَ ووازن وأَرسى مكتَشفاتِه على أسُسٍ وأركان.
وقد مرّ معنا أنّ الإنسان في مذهب علي بن أبي طالب هو الصورة المثلى للكون الأمثل. وممّا يُعزى إليه هذا القولُ يخاطب به الإنسان:
وتحسبُ أنّك جرمٌ صغيرٌ
وفيك انطوى العالَمُ الأكبر
فمن الطبيعيّ في هذه الحال أنْ يُلحّ عليّ في طلب كلّ ما يتعلّق بالإنسان ممّا يطاله زمانُه وإمكاناتُ عصره. ومن الطبيعيّ كذلك أنْ يُلحّ في الكشف عمّا في هذا (الجرم الذي انطوى فيه العالَم الأكبر) مِن مظاهر العدالة الكونية وتكافؤ الوجود ضمْن الإطار الذي دارت آراؤه فيه.
أحسّ عليّ إحساساً مباشراً عميقاً أنّ بين الكائنات روابطَ لا تزول إلاّ بزوال هذه الكائنات. وأنّ كلّ ما يُنقص هذه الروابط يُنقص مِن معنى الوجود ذاته. وإذا كان الإنسانُ أحد هذه الكائنات، فإنّه مرتبطٌ بها ارتباطَ وجود. وإذا كان ذلك - وهو كائنٌ - فإنّ ارتباطَ الكائن بشبيهه أجدرُ وأولى. أما إذا كان هذا الكائنُ من الأحياء، فإنّ ما يشدّه إلى الأحياء من جنسه أثبتُ وأقوى. وأما الإنسان - رأس الكائنات الحيّة - فإنّ ارتباطه بأخيه الإنسان هو الضرورة الأولى لوجوده فرداً وجماعة.
وحين يقرّر عليّ أن المجتمع الصالح هو المجتمع الذي تسوده العدالة الاجتماعية بأوسع معانيها وأشرف أشكالها، إنّما يسن قانوناً أو ما هو من باب القانون. ولكنّ هذا القانون لا ينجلي في ذهنه ولا يصبح ضرورة، إلاّ لأنه انبثاقٌ طبيعيّ عمّا أسميناه روح العدالة الكونية الشاملة، التي تفرض وجودَ هذا القانون. لذلك نرى ابنَ أبي طالب ملحّاً شديد الإلحاح على النظر في ما وراء القوانين، وعلى رعايتها بما هو أسمى منها: بالحنان الإنساني.
وما يكون الحنان إلاّ هذا النزوع الروحيّ والماديّ العميق إلى الاكتمال والسموّ. فهو بذلكٍ ضرورةٌ خلقيّة لأنه ضرورةٌ وجودية.
الصفحة الأولى التي ينشرها عليّ من صفحات الحنان تبدأ بأن يذكر الناس بأنهم جميعاً أخوة فينعتهم بـ(إخواني) نعتاً صريحاً وهو أميرٌ عليهم. ثم يردف ذلك بتذكير الوُلاة بأنهم إخوان الناس جميع الناس، وبأنّ هذا الإخاء يستلزم العطف بالضرورة، قائلاً إلى أمرائه على الجيوش: (فإنّ حقّاً على الوالي أنْ لا يُغيّره فضلٌ ناله، ولا طَولٌ خُصّ به، وأنْ يزيده ما قسم الله له من نِعَمه دنوّاً من عباده وعطفاً على إخوانه). وما يذكره لنفسه وللولاة بأنّهم والناس إخوانٌ بالمودّة والحنان، يعود فيقّرره بحكمة شاملة يتّجه بها إلى البشر جميعاً دون تفرقة أو تمييز، قائلاً: (وإنما أنتم إخوانٌ ما فرّق بينكم إلاّ خبث السرائر وسوء الضمائر). وهو بذلك يضع خبثَ السريرة وسوءَ الضمير في طرف، وحنانَ القلب ومودّةَ النفس في طرفٍ آخر. ولمّا كان من الحقِّ الوجوديّ للإنسان أن ينعم بحنان الإنسان، فإنّ الطبيعة التي تحمل بذاتها القيَمَ والمقاييس لابدّ لها من التعويض على صالحٍ ضَيّعَه الجيرانُ والأقربون والأهل فما لفّوه برداءٍ من حنان، بعطفٍ وحنانٍ كثيرين بإتيانه من الأباعد، فيقول عليّ: (مَن ضيّعَه الأقربُ أُتيح له الأبعد!).
وهو في سبيل رعاية هذه الأخوّة القائمة بالحنان الإنساني، لا يقبل حتى بالهَنات الهيّنات لأنّ فيها انحرافاً مبدئياً عن كرَم الحنان: (أمّا بعد، فلولا هَناتٌ كنّ فيك لكنتَ المقدّمَ في هذا الأمر).
وإذا كانت القوانين المتعارَف عليها تسمح عليها تسمح لابن أبي طالب بأن يحارب المتآمرين به، فإنّه لا يفعل إلاّ بعد أن يراعي كلّ جوانب الحنان في نفسه وقلبه، وبعد أن يستشير كلّ روابط الإخاء البشريّ في نفوس مقاتليه وقلوبهم. وهو إنْ فعل في خاتمة الأمر فإنّما يفعل مُكرَهاً لا مختاراً، حزيناً باكياً فرِحاً ضاحكاً، فإذا شعوره بالنصر بعد القتال آلَمُ وأوجعُ من شعور مناوئيه بالهزيمة!
وإذا كانت القوانين المتعارَف عليها تسمح لابن أبي طالب بأن يترك المعتدين عليه، بعد موته، بين يدي أنصاره وبنيه يقاتلونهم ويقتصّون منهم لضلال مشَوا به وإليه، فإنّ الرأفة بالإنسان وهي لديه وراء كلّ قانون، تحمله حمْلاً على أن يخاطب أنصاره وبنيه بهذا القول العظيم: (لا تقاتلوا الخوارج من بعدي، فليس مَن طلب الحقّ فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه).
وهو بعامل هذا الحنان العميق يربط سعادة المرء بسعادة جاره، أي بسعادة الإنسانية كلّها، لأنّ لجار المرء جيراناً، وما يجوز عليه بالنسبة له يجوز عليهم بالنسبة لسائر الناس. ومن سعادته أيضاً أن يطغى عليه هذا الحنان فإذا بأبناء الآخرين يحظون منه بالعطف الذي يحظى به أبناؤه: (أدِّبِ اليتيم بما تؤدِّب به وُلْدَك). وأنّ يستشعر الجميع روحَ العدالة الأساسية التي تفوق القوانينَ الوضعية قيمةً وجمالاً لأنها تحمل الدفءَ الإنسانيّ وتصل الخلقَ بمنطق القلب لا بمنطق الخضوع لقانون: (ليتأسّ صغيركم بكبيركم، وليرأفْ كبيركم بصغيركم).
وإذا كان العجز عن إتيان المكرمات نقصاً، فإنّ منطق الحنان على لسان عليّ يجعل العاجز عن اكتساب أخوّة الناس أكثرهم نقصاً: (أعجز الناس مَن عجز عن اكتساب الإخوان). ويضيفُ عليٌّ إلى هذا العجز عجزاً آخر هو الميل إلى المراء والخصومة قائلاً: (إيّاكم والمِراء والخصومة) بل إنّ الأولى هو لين الكلام لِما فيه من شدّ الأواصر بين القلب، منبع الحنان، والقلب: (وإنّ من الكرَم لين الكلام). وليس بين نزعات القلب ما هو أدعى إلى الراحة من شعور المرء بأنّ له في جميع الناس إخواناً أحبّاء، فإذا تألّم ابنُ أبي طالب من سيئات زمانه، جَعَلَ الخبزَ وهو آلة البقاء، والصدقَ وهو ركيزة البقاء، ومؤاخاةَ الناس في منزلة واحدة، فقال في ناس زمانه: (يوشك أن يفقد الناس ثلاثاً: درهماً حلالاً، ولساناً صادقاً، وأخاً يُستراح إليه).
وإذا كانت الغربةُ قساوةً كبرى لأنها تستدعي الوحدة، فإنّ أشدّها يكون ساعةَ يفقد الإنسان إخوانه وأحبّاءَه لأنه يفقد إذ ذاك قلوباً يعزّ بعطفها ويحيا بحنانها: (والغريبِ من لم يكن له حبيب) و(فقْدُ الأحبّة غربة).
للمقال تتمة......
| |
|
|
|
|
|



